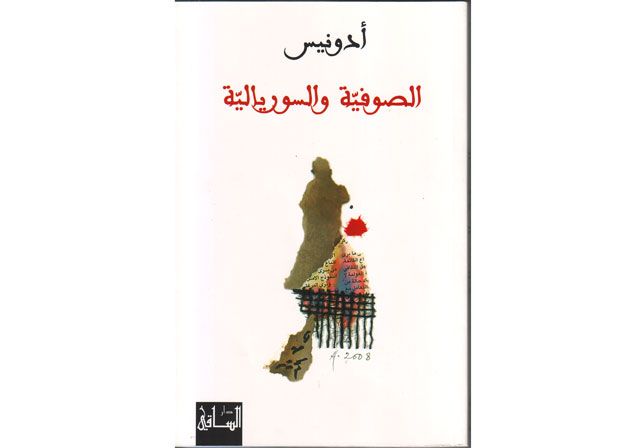
المقاربة التي يقدّمها أدونيس في كتابه "الصوفية والسوريالية" تنحت في الموروث معرفة به، وانفتاحاً وهضماً وإضافة على مستوى الرؤية فيما يتعلق بتتبّعه لنشوء وتطور السوريالية في العصر الحديث، تفكيكاً واستجواباً واستظهاراً لعلامات تقارب بينها وبين الصوفية، يوردها في ثنايا الكتاب، على رغم تباين أيضاً حاصل بالتناول المباشر للمفهومين أو المصطلحين، أو الرؤيتين في المحصلة النهائية. وثمة اعتراض نشأ ليس مع بداية اشتغاله على البحث، بل هو قائم منذ امتداد الرؤيتين وشيوعهما في مساحة ليست بسيطة على خريطة العالم، لمس بعضه بشكل مباشر، فيما بعض كان تتبّعاً للدراسات والقراءات في هذا الشأن، وفوق هذا كله، هو من الأساس اعتراض ناشئ وقائم بالنظر إلى طبيعة تأسيس وقيام ونشوء كل منهما.
" الاعتراض الأساسي الذي يمكن أن ينشأ هو، أن الصوفية تديّن، وأنها تتجه نحو الخلاص الديني، بينما السوريالية حركة إلحادية، ولا تهدف إلى أي خلاص سماوي، فكيف يمكن الجمع بين متديّن وملحد"؟
ولا يحتاج أدونيس أن يعترف بذلك الاعتراض، ظاهرياً على أقل تقدير، لأنه قائم وصحيح، وأورد ذلك في مقدّمة الكتاب: "مثل هذا الاعتراض صحيح، ظاهرياً: غير أنه لا يلغي عميقاً إمكان التقارب أو إمكان التلاقي في نقاط عديدة، على الطريق التي تسلكها، معرفياً، كل من الصوفية والسوريالية".
في هذا الاعتراض يورد ملمحاً من ذلك التقارب أو التلاقي، من حيث إن الإلحاد لا يتضمّن بالضرورة رفض الصوفية، والأمر نفسه ينطبق على الصوفية من حيث عدم ضرورة الإيمان بالدّين التقليدي، كما هو في جموده، ومباشرته وانغلاقه والمجافاة على مستوى التأويل وحبْسه. يحضر أندريه بريتون في هذه الإشكالية من حيث كونه قارئاً ومتناولاً للمسألة الدينية بقوله، إنه ليس لله – بالمعنى الديني التقليدي – أي حضور في التجربة السوريالية، ويورد ذلك في تناوله للمقدّس/ الدّين، فيما يراه، أن المقدّس الذي يؤمن به ليس دينياً، أو هو خارج الدين. إذاً ثمة مقدّس في المسألة، تبقى تسمية أو النظر إلى ذلك المقدّس من حيث هو المحور في التفاصيل، أو في جزئية منها، وأحياناً عدمها.
في تقصٍّ لنشوء الصوفية وأسباب قيامها، بالاتجاه الذي "أملاه عجز العقل"، عن الجواب عن كثير من الأسئلة العميقة عند الإنسان، ذلك من جهة، من جهة ثانية، أملاه أيضاً عجز العلم. مثل تلك المشكلات في السؤال والتساؤل، والنهم إلى الإجابات "تؤرّق الإنسان" وخصوصاً مع تعدّد تلك المشكلات وتعمّقها. في تلازم بين: "هذا الذي لم يُحَل (لا يُحّل)، والذي لم يُعرَف (لا يُعرف)، والذي لم يُقَل (لا يُقال)!
يستعرض أدونيس مقالة ل "غي رينيه دوميرو" يتناول فيها السوريالية، بتقريره أنها "تهتم عميقاً باللامعقول، لكن ليس إلى حد الإيحاء بإيمان ما، بإله أو ألوهة ما"، وصولاً إلى اللامعنى في التمييز بين الخيالي والواقعي.
بين أندريه بريتون، غي رينيه دوميرو، ميشال كاروج، وبيار كلوسوفسكي، يحضر ابن تيمية في فتواه: "لمّا كانت أحوال هؤلاء شيطانية (الصوفيون)، كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى عليهم، كما يوجد في كلام صاحب (الفتوحات المكية) و (الفصوص) وأشباه ذلك، يمدح الكفّار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم، وينتقص الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وهارون، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين، كالجنيد بن محمد وسهل بن عبدالله التستري، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلّاج ونحوه، كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية". (الفتاوى: 11/ 239، الرياض 1382هـ). أدونيس يرى الفتوى المذكورة صحيحة، من وجهة نظر الفهم الظاهري - التقليدي للنص القرآني، ويورد سبب ذلك بأنه "ليس في النص القرآني، كما فهمه المسلمون الأوائل، ولا في الحديث النبوي، إذاً فهماً ظاهرياً - شرعياً، بحسب التقليد الاتّباعي، ما يمكن أن يُعدّ مصدراً مباشراً للرؤيا الصوفية. على العكس، ليس في هذه الرؤيا إلا ما يتناقض ظاهرياً مع النص الديني، لا على صعيد النظر إلى الخالق فحسب، بل أيضاً على صعيد النظر إلى الخلق".
وعلى النقيض من ابن تيمية تحضر رؤية الصوفي أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني، حين يتناول أصل التصوف بالقول: "أما موضوعه فهو الذات العليّة لأنه يبحث عنها باعتبار معرفتها، إما بالبرهان، أو بالشهود والعيان، فالأول للطالبين والثاني للواصلين...".
في تداعٍ للاستشهادات، يتم التركيز على أن التجربة الصوفية، في إطار اللغة العربية، ليست مجرد تجربة في النظر، وإنما هي أيضاً، وربما قبل ذلك، تجربة في الكتابة. إنها نظرة أُفصح عنها بالشعر.
وضمن مقاربة الكتاب نفسها، يورد أدونيس أن السوريالية "توحّد، شأن الصوفية بين الكتابة والحياة، فلا يكفي أن نكتب الشعر، مثلاً،و إنما يجب أن نحياه".
وفي المجاز يحضر التلاقي بين "الصوفية" و "السوريالية"؛ إذ إنه ليس مجرد أسلوب، وإنما هو كذلك رؤيا"، وصولاً إلى ابن عربي ورؤيته بأن العالم الروحاني يظهر في صور محسوسة، فيقول عن الجان، مثلاً: "إن الجني إذا ظهر في صورة حسية يقيده البصر بحيث لا يقدر أن يخرج عن تلك الصورة مادام البصر ينظر إليه بالخاصية...".
في ختام كتابه يورد أدونيس نظرته إلى الشاعر رامبو، الذي يبدو له جديداً، في إطار الثقافة الغربية، لكنه في إطار الثقافة العربية جديد جزئياً؛ أي أنه جديد بطريقة تركيبه العناصر وإفصاحه. وكما "كان رامبو صوفياً في كلامه، كان كذلك صوفياً في صمته".
الكتاب في مقاربته مليء باقتباسات واستشهادات غلبت عليها الأسماء الفرنسية، وخصوصاً أنها الأكثر تناولاً وتعميقاً وتأصيلاً للسوريالية من جهة، ووجود أسماء كبيرة من بينها اهتمت اهتماماً بالغاً بالرؤية الصوفية في الثقافة العربية والإسلامية، وأشبعتها إما ترجمة وإما تناولاً وبحثاً وكشفاً. بين هذه وتلك، كانت لأدونيس رؤيته وقراءته من عمق الثقافة العربية والإسلامية التي نشأت فيها الحركة الصوفية، تناولاً لأقطابها بالنصوص وقراءتها، وكذلك الذين كانوا يشكّلون مانعاً وحاجزاً لها عن التمدّد عبر فتاوى "تكفيرها وإلحاقها بالشيطان" وتوابعه!



