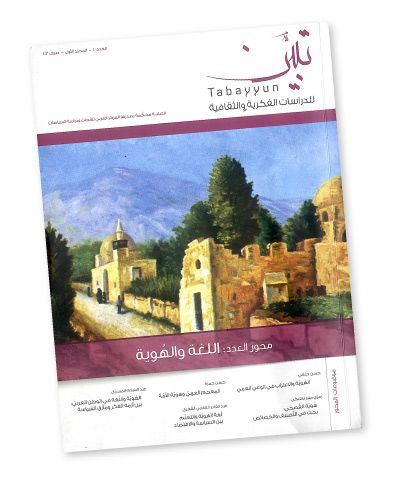
في مجلة «تبيُّن» في عددها الأول الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في دولة قطر، التي يرأس تحريرها المفكر العربي عزمي بشارة، ويديرها ثائر ديب، تحضر أسماء فاعلة وناقدة وفاحصة في المدار الثقافي والإبداعي العربي. أسماء قلقة ومقلقة في الوقت نفسه. قلقة بطبيعة الأسئلة التي تطرح من دون أن تنتظر إجابات أو تهتم هي نفسها بتلك الإجابات. ليس ذلك دورها. ليس دور المفكر أن يجيب على الأسئلة. دوره أن يسأل ... يتساءل. وفي ذلك وحده عصف ليس هيّنا.
اهتمّ العدد الأول بمحور اللغة والهويّة. ساهم فيه كل من: المفكر المصري، حسن حنفي،وعالم اللغة واللسانيات، رمزي منير بعلبكي، والخبير اللساني الدولي عبدالقادر الفاسي الفهري، وأستاذ اللسانيات العربية والمصطلح والترجمة في جامعة ليون 2 الفرنسية، حسن حمزة، وعالم اللغة واللسانيات، عبدالسلام المسدّي.
في «الهوية والاغتراب في الوعي العربي»، يعود حسن حنفي في ورقته إلى الغوص في معنى الهوية وارتباطها الجدلي باللغة، ويرى أن الهوية تتحول إلى اغتراب عندما تنقسم الذات على نفسها بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، وذلك بسبب الاستبداد الواقع عليها. ويفرّق بين أشكال عديدة من الاغتراب، مشدّداً على العلاقة المتينة بين الهوية والحرية. ويؤكد أن انتقال التعدّدية اللغوية إلى مستوى الثقافة يؤدّي إلى تفتيت الأوطان إذا لم يتم استيعابها في مشروع حضاري واسع، يقبل التحدي التاريخي، وهو ما بدتْ مؤشراته في الثورات العربية التي أنتجتْ لغة جديدة تعبّر عن استرداد الهوية ونهاية الاغتراب.
رمزي منير بعلبكي، يقدّم في دراسته «هوية الفصحى... بحثٌ في التصنيف والخصائص»، حفراً لغوياً وتاريخياً مقارناً في أصول اللغة العربية بوصفها بنتاً للساميّة، وتتفحّص أهم النظريات التي تناولت تشكّلها التاريخي واللغوي، وتساهم في تحديد موقعها التصنيفي في مجموعتها، وموقعها التاريخي في التطوّر اللغوي للأصول التي انبثقت منها. وتبيّن الدراسة المعالم الكبرى التي طبعت العربية بطابع انتمائها الساميّ، على المستوى الصوتي والصرْفي والتركيبي والدلالي. كما تبيّن أيضاً الظواهر التي انفردت بها عمّا في سائر الساميّات أو توسّعت بها عنها، حتى أضحتْ سمات مميزة لها، وأكسبتْها تفرّدها وهويتها الخاصة.
دراسة عبدالقادر الفاسي الفهري، «لغة الهويّة والتعلّم بين السياسة والاقتصاد... نموذج تماسكي تنوّعي تعدّدي»، تبحث في التشكّل التاريخي والاجتماعي لأزمة اللغة في المغرب العربي، والتي ساهمت فيها سياسات لغوية لنخب سياسية واقتصادية وأدبية وفكرية فرانكفونية، وعزّزتها أيضاً تشريعات دستورية تقرّ بازدواجية اللسان المغربي، لتصبح العربية لغة الشارع والفرنسية لغة النخبة والمصلحة والقرار. ويركّز البحث على دور سياسات اللغة في تشكيل خريطة القوى السياسية والاجتماعية في المغرب، وإنتاج جماعات مصالح وضغط أعادت إنتاج اللاتكافؤ، وأعادت توزيع مقدّرات القوى والسلطة؛ الأمر الذي سمح لجماعة لغوية أخرى هي «الأمازيغية» بحجز موقع لها في الدستور الجديد. بحث حسن حمزة «المعجم العربي وهويّة الأمة»، يفحص المعجم العربي منطلقاً من مقولة، إن المعجم هو المكان الطبيعي الذي يعكس نظرة اللغة إلى العالم، وهو يعكس أيضاً تطوّر اللغة وتطوّر أهلها. ويتوقف الكاتب عند نزوع صنّاع المعاجم إلى «السلفية اللغوية» بإقفال باب التجديد، وذلك بدعوى الحفاظ على فصاحة اللغة ونقائها، وهو ما قاد إلى قطيعة بين المعجم واللغة التي يعاين مفرداتها، ليحوّل نفسه إلى «مدوّنة ليس فيها إلا الأموات». وتخلص الدراسة إلى أن اللغة العربية تخضع لامتحان عسير بعد احتكاكها بالمستعمر الأوروبي السابق ولغاته؛ الأمر الذي يستدعي ثورية معجمية جديدة.
يشارك في محور اللغة والترجمة، كل من: أستاذ اللسانيات الفرنسية وعلم اللغة المقارن في الجامعة اللبنانية، بسّام بركة، ببحث تحت عنوان «الترجمة إلى العربية... دورها في تعزيز الثقافة وبناء الهوية» يناقش فيه الجدلية بين تطوّر اللغة واستعمالها على أيدي أبنائها، مستنتجاً أن تطوّر اللغة العربية وتطوّر المعرفة والثقافة العربيتين يرتبطان بالدور الذي تضطلع به الترجمة إلى اللغة الأم. ويخلص إلى أن المعرفة وحدها (منقولة عن الفكر الأجنبي أم أصلية) لا تكفي عربياً لمواكبة الحضارة العالمية، فإذا لم تكن المعرفة وسيلة يتخذها أبناء اللغة الواحدة من أجل تكوين تيارات فكرية خاصة بهم تحصّن ثقافتهم وتسهم في بناء هويتهم، فإن هذه المعرفة المنقولة ستبقى في طيّات الكتب ولن تؤتي ثمارها المرجوّة.
تنطلق دراسة عالم الاجتماع ومنسق وحدة «ترجمان» في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فايز الصُيّاغ، تحت عنوان «إشكالية الهوية وثنائية اللغة والترجمة في السياق العربي المعاصر»، من مسلّمة أساسية مفادها أن الهوية - ببعديها الفردي والجمعي - لا يمكن استنساخها بقضّها وقضيضها عبر الأجيال والحقب التاريخية. فالتفاعل والتثاقف الحضاريان، هما عاملان حيويان في تشكيل الهوية الجماعية للشعوب بوصفها نتاجاً لصيرورة تراكمية تاريخية تنفي عنها صفات التأبّد والثبات والديمومة والسكون. وتعرض الدراسة تحليلاً مقارناً لما آلت إليه ثلاث مقاربات برزت في الساحة العربية منذ بدايات عصر النهضة وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين تجاه القضايا المتصلة بالهوية الثقافية والقومية عموماً، والتفاعل الحضاري العربي - الغربي خصوصاً. كما تستعرض جانباً من التحديات والإشكالات التي قد تواجهها آخر هذه المقاربات، المتمثلة في المنظور القومي الديمقراطي النضالي، إزاء ما قد يتمخّض عنه «الربيع العربي» على الصعيد السياسي في المستقبل المنظور.
مدير تحرير «تبيّن» ثائر ديب يترجم مقالة عالم اللغويات البريطاني، ليونارد جاكسون «شكلان من المادية الثقافية ... المادية في الأنثروبولوجيا وفي الدراسات الثقافية»؛ إذ يدافع الباحث عن تلك المادية التي تستخدم في الأنثروبولوجيا، وهي مادة متشدّدة علمياً وتقوم على أساس اقتصادي مكين، كما يرى بخلاف تلك التي تستخدم في الدراسات الثقافية والنظرية الأدبية السائدة، التي يجد أنها تُسقط العلم والأساس الاقتصادي؛ فضلاً عن اتسامها بالنسبوية وبراديكالية من النوع الشكلي.
«دولة ما بعد الاستعمار والتحوّلات الاجتماعية في ليبيا» دراسة لأستاذ العلوم السياسية في جامعة نيو إنغلند في مدينة بدفورد بولاية ماين الأميركية، علي عبداللطيف احميدة، تحاول تفحّص موضوع الدولة والتحوّلات الاجتماعية عقب استقلال ليبيا العام 1951، من خلال تقييم بنية نظام الملكية السنوسية والنظام الذي أعقب الثورة العسكرية العام 1969 وخصائصهما، دون الوقوع في فخ الأساطير التي نسجتها التقارير والتعليقات التي أعقبت الثورة الليبية العام 2011. وتوضح الدراسة أن الأنظمة والأيديولوجيات التي تعاقبت على الحكم في ليبيا كانت متحوّلة ومتغيّرة بحسب تبدّل الظروف المحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة، وتغيّر الوضع الإقليمي والدولي المحيط من جهة أخرى. وتوصل الكاتب إلى أن انهيار نظام «الجماهيرية» كان سببه الأساسي معاداة المأْسسة، وتسلط الأجهزة الأمنية على البناء المؤسسي، وهما العاملان اللذان تسبّبا في اغتراب الطبقتين الوسطى والدنيا، إضافة إلى انشقاق عديد من الإصلاحيين وضباط الجيش والدبلوماسيين الذين غدا بعضهم من قادة الانتفاضة الديمقراطية الآن. تضمّن العدد خطاب يورغن هابرماس «الحداثة - مشروع لم يكتمل»، وهو نص كلمة ألقاها يوم 11 سبتمبر/ أيلول 1980، في باولسكيرش بمناسبة تسلّم جائزة أدورنو التي تمنحها مدينة فرنكفورت الألمانية. قام بترجمة نص الكلمة المفكّر التونسي، فتحي المسكيني. في باب «مناقشات ومراجعات» تضمّن العدد: مارك بلوخ: من فكرة «المجتمعات الحزينة» إلى التأريخ لأزمة التحوّل وأزمنتها، ولماذا ترجم عبدالله العروي نص «دين الفطرة» لروسو؟، وقراءة في كتاب «فكرة العدالة» لأمارتيا صن، ومراجعة كتاب: «فلسفة حضارات العالم: نظريات الحقيقة وتأويلها»، وكتاب: «في المسألة العربية، مقدّمة لبيان ديمقراطي عربي».
العدد 3724 - الجمعة 16 نوفمبر 2012م الموافق 02 محرم 1434هـ
