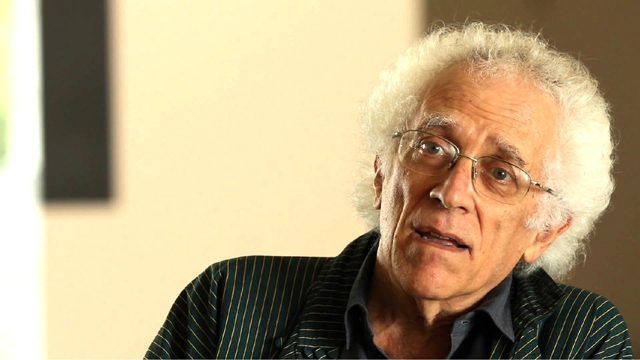
يبدو تساؤلاً أكثر من كونه سؤالاً «لماذا نقرأ الروايات»؟ لو وقف الناس عند التساؤل نفسه لما توفر لهم وقت لقراءة الروايات أصلاً، أو حتى الأجناس الأدبية الأخرى. القراءة تلبية لشغف في النفس الإنسانية: المعرفة. ربما يكون أكثر من شغف بوصوله إلى درجة الفضول. هو ربما ما يدلنا على أنفسنا ويكشف غموضها وأسرارها، وغموض وأسرار الآخرين.
تحقيق هيلوزا ليريتي، والذي حمل عنوان «لماذا نقرأ الروايات»، المنشور في مجلة «الدوحة» القطرية في عددها 112 لشهر فبراير/شباط 2017، ومن ترجمة محمد الإدريسي، يضعنا أمام مجموعة من الأفكار والمداخلات التي توزعت أو قيلت إما في حوارات، أو في جزء من مقالات، أو حتى في تعقيب ربما لا علاقة له بموضوع التحقيق، لكنه يقدم رؤية ولو سريعة وعابرة بشأن هذا التساؤل السهل ظاهراً، العميق بالنتيجة التي يحققها استدراج التحقيق.
يضعنا تحقيق ليريتي، بداية، أمام حقيقة حضور وشعبية الرواية في فرنسا خصوصاً، بالإشارة إلى أن الأعداد التي تباع منها تفوق، ست مرات، أكثر مؤلفات العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى أدب الشباب المزدهر.
في سؤال ثانٍ يرد في التحقيق: لماذا هذا النجاح الباهر؟ «الإجابة ليست واضحة، فالرواية لا تدّعي الحقيقة أو الموضوعية، وقراءتها تتطلّب جهداً لعدّة ساعات، أو عدة أيام أو حتى أسابيع». سؤال ثالث، إذا ما احتسبنا السؤال أو التساؤل الذي حمل عنوان التحقيق: لأي هدف نقرأ الروايات؟ ورابع: وما الذي نربحه منها؟ وخامس: ما الذي نبحث عنه من خلال قراءة الرواية، والذي لا يمكن أن نجده، لا في الأعمال النظرية ولا في الأعمال العملية، ولا في الأفلام، ولا في طوفان وسائل الترفيه المتاحة للاستهلاك المعاصر؟ سيل من الأسئلة لكنها تصب في نهاية المطاف حول الأثر الذي يمكن أن يحدثه عمل روائي، في الوقت الذي تعجز عنه أعمال أخرى. على رغم أن مجال الرواية ليس العلم الذي يمكن احتساب مقدماته ونتائجه بدقة، إذ مجاله الخيال، ولا يمكن لأي مقدمات أو نتائج أن تكون رهينة لمثل ذلك الخيال، فمن طبيعته أنه خارج على المرسوم والمنضبط والمحدّد، بالانتقالات التي تشيع في عالم الرواية. بناء الرواية شيء، والتقاط عوالمها شيء آخر.
الفرنسيون هم الذي حملوا هذا الفن إلى العالم في أروع صوره، ومضامينه المدهشة التي كانت على ارتباط مباشر مع الواقع. الشخصيات والوجوه والحالات الإنسانية لم تكن محض خيال، لكن مخيلة الأديب أسبغت عليها روحاً أكبر من الروح التي كانت تحملها، وعملت اللغة عملها في استدراج القارئ إلى عوالم وشخصيات ربما يشاهدها يومياً، لكنها في العمل الروائي ذات لون وطعم وروح أخرى.
البدء من موباسان، وملاحظاته على بعض النقاد الذين يقررون أن هذا عملاً روائياً، وذاك خلاف ذلك: «إن الناقد الذي يجرؤ على كتابة: (هذه هي الرواية، وليست تلك)، يبدو لي أنه موهوب، ببصيرة تحيل، بقوة، إلى عدم الكفاءة»!
تحقيق ليريتي يشير إلى أن الرواية «لا تعرض الحقائق، ولا تستعرض المفاهيم، ولا تجابه الأفكار. أمام الصرامة العلمية، نجدها تعارض العشوائية واللاتوقع، وفي مواجهة الكوني والمفهومي، نجدها تناشد التفرّد، والزوال، والصغر، والحسية، وصدفة اللقاء، وضربات القلب، وعنف المشاعر أو المشادّات الكلامية (...)».
الأدب عموماً ينزع إلى المعرفة الأفضل للإنسان بحسب ما تؤكده بعض الأصوات النقدية، «بالقوة الكشفية» التي يمتلكها أو «القوة المعرفية». بمعنى «ما نسعى إليه، من خلال الروايات، هو معرفة أفضل بالإنسان، والعالم، والحياة». تزفيتان تودوروف لم يكن بمنأى عن هذا المعنى، والأكثر سفوراً في الانحياز إلى الأدب بقوله: «الأدب يتصدّر العلوم الإنسانية». وفي تنويع لعدد من الرؤى يضعنا تحقيق ليريتي أمام ما يعتقده كل من: جيرار جانيت، جان ماري شيفر، راينر روشليز، الذين لا يبتعدون كثيراً عن الاعتقاد بأن «إسهام الرواية يكمن في البعد المعرفي».
سؤال هو في الصميم من هذا المبحث: ما نوع المعرفة الدقيقة التي تقدمها لنا الرواية؟ يجيب التحقيق «يمكن للروايات أن تعيد بناء الكون التاريخي، وتفك تشفير العلاقات الاجتماعية، وتخبرنا، بشكل واضح، عن خفايا النفس البشرية، لكن، ومن وجهة النظر هذه، نجد أنها لا تملك أي تفرّد يُذكر، مقارنة مع باقي العلوم الإنسانية، وباقي السرديات، والسينما (...)».
هناك تقريب أكثر لمعنى أن نقرأ رواية، يوضح مساحته تحقيق ليريتي؛ إذ «نكتشف أن القراءة - أيضاً - هي عملية عاطفية شديدة التشابك، فأية رواية تخاطب ذكاءنا، تخاطب - أيضاً - قلوبنا»، واضعاً التحقيق إيانا أمام مقاربة أمبرتو إيكو «الذي قارن بين قراءة رواية ولعبة الشطرنج».
هل تبدو مثل تلك الأفكار حاضرة لدى كثيرين قبل وبعد قراءة أي عمل روائي؟!



