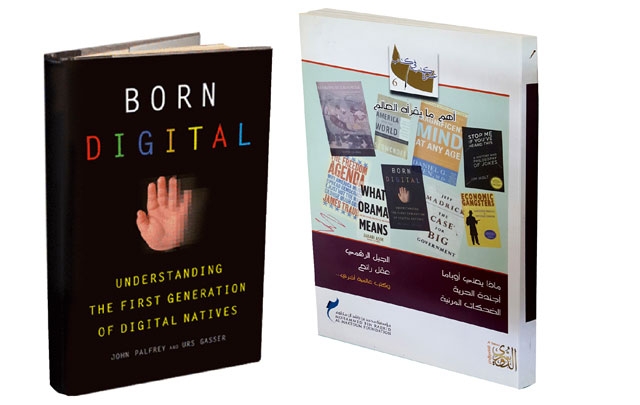يتضمَّن كتاب «الجيل الرقمي»، لكل من المدير التنفيذي بمركز بيركمان للانترنت والاجتماع، والمحاضر في كلية القانون بجامعة هارفارد، جون بالفري، ورئيس مركز بركمان لللإنترنت والاجتماع في جامعة هارفار، أورس غاسر، قصة يحكيها جوناثان إيم، في ثنايا مقالة حملت عنوان «كائنات رقمية»، يستنتج منها مؤلفا الكتاب أن جوناثان إيم فقد القدرة على التواصل مع الآخرين، مُفضِّلاً التواصل من خلال وسائل الاتصال الحديثة، بسبب تعطُّل تلك الوسائل والإحباط الناتج عن ذلك، متسائلاً: هل أصبحنا نفضِّل الحياة الرقمية (الافتراضية) على الحياة الواقعية الحية المباشرة؟
مُلخَّص القصة كما يرويها إيم «ذات يوم أنهيت أعمالي في أحد المؤتمرات، وأخذت القطار عائداً إلى بيتي. وفي إحدى المحطات تعطَّل فظللت عالقاً نحو ست ساعات بالقرب من بلدة صغيرة يبدو أنها تعاني من فقر الخدمات. فلا يوجد سوبر ماركت ولا ماكدونالدز. ولم يكن عندي أدنى رغبة في الحديث مع أي شخص. فقط أنا والسكة الحديد. أسرعت إلى كتابي الإلكتروني فوجدت البطارية فارغة. أخرجت الآي فون فوجدته في وضع الإيقاف لعدم وجود تغطية اتصال. وتساءلت، ما الذي يمكن أن أفعله على هذه الأرض إلى أن يأتي قطار آخر؟ وشعرت بالبؤس الشديد؛ فلا (تويتر) هنا، ولا بريد إلكتروني، ولا رسائل صوتية، ولا موسيقى، والهاتف المعمول لا يعمل. كنت ببساطة معزولاً عن العالم الخارجي دون إرادة مني؛ فضلاً عن أنني لم أسمع أخباراً منذ ساعات. ولعل ما أزعجني إلى درجة الضيق أنني شعرت بعدم قدرتي على إخبار أي شخص آخر عن حالة البؤس التي أعانيها».
كل تلك التحوُّلات في وسائل الاتصال الحديثة أحدثت ثورة شاملة على مستوى تعامل وتعاطي الإنسان مع الحياة من حوله، وقدرة تلك الوسائل على أن توجد بدائل لم يكن أحد يتصوَّر يوماً ما أنها يمكن أن تتحقق بإيجاد عالم افتراضي، لم يعد افتراضياً في حقيقة الأمر؛ بدليل التقارب والاندماج الذي حققه الإنسان في عمق ذلك العالم، والنتائج التي تمخضت عنه من تغيير مفاهيم وطرق وأشكال الأعمال والعلاقات بين البشر أنفسهم، والتي مثلت فيه تلك الوسائل الوسيط النموذجي، من دون أن نملك خيار رفضه أو إقصائه، على الأقل في ما نشهده من رتْم الحياة وإيقاعها الحالي.
برينسكي والإنسان الرقمي
ربما نحتاج إلى العودة إلى «الإنسان الرقمي»، عنوان الكتاب الذي أصبح مصطلحاً وضعه الأستاذ الجامعي المُتخصص في تصميم ألعاب الفيديو مارك برينسكي ونشر في العام 2001. الكتاب عبارة عن مشروع خضع لدراسة قسَّم من خلالها برينسكي المشاركين إلى مجموعتين، المجموعة التي لا تحسب على الطفرة الرقمية، وكانت سابقة لها، والأخرى التي عاصرتها أو ولدت في ظلها. مشروع الدراسة تمت إدارته من قبل كل من: مركز بيركمان للانترنت والمجتمع في كلية الحقوق بهارفارد، ومركز الأبحاث للتحكُّم بالمعلومات في جامعة ست غالين في سويسرا.
لبرينسكي رأي في مسألة المدرسة الرقمية بحسب ما نشرته صحيفة «الحياة» في عددها 16800، بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2009، استناداً إلى مقال نشره على مُدوّنته الإلكترونية؛ حيث يرى برينسكي، صاحب فكرة «المواطن الأصلي الرقمي» (Digital Natives)، أن التكنولوجيا المعاصرة تداخلت مع المعارف المعاصرة إلى حدّ أنها تفرض تغييراً جذرياً في التربية والتعليم. ويشير إلى أن «جيل الديجيتال» يقدر على صناعة العلم والمعرفة بنفسه، من دون حاجة إلى أستاذ قد يكلمه أحياناً بلغة تقادم عليها الزمن. ويُنبّه إلى أن هذا الجيل ترعرع في ظل ثورة الكومبيوتر والمعلوماتية والانترنت وتملّك مفاتيحها واستوعب تقنياتها وفك رموزها، ويستخدمها يومياً بحيث أنها أصبحت جزءاً من حياته الشخصية.
ما تقدَّم يعيننا على فهم الكتاب موضوع هذه المراجعة، والذي تم استعراضه ونشرت نبذة منه ضمن سلسلة «10 كتب في كتاب»، وإن كانت قد توقفت، وهي ضمن مشروع تبنَّته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وتعاونت فيه مؤسسة الدوسري للثقافة والإبداع، التي لم نعد نسمع شيئاً عن نشاطها اليوم.
نيتشه... العالم... المعنى
في جانب من فصل الكتاب، وفي حديثه عن الحياة الافتراضية، ينطلق بالفري من مقولة نيتشه، وإن لم يضمِّنها حرفياً «جئنا إلى هذا العالم لكي نمنحه معنى»، بالقيمة الإضافية الكبرى التي يُمكن للإنسان أن يحققها، وبقدرته على أن يكون سبَّاقاً في زمنه بالمبادرات التي تحمله إلى المستقبل، بمنهجية عالية؛ ما يتيح في المحصلة النهائية، سهولة ويسراً للحياة نفسها. ذلك جزء من المعنى أيضاً الذي رمى إليه نيتشه. هنا يركِّز بالفري على فلسفة نيتشه عن إرادة القوة، وفي ذلك متاخمة لموضوع إعادة الاعتبار إلى الإنسان، بوصفه القيمة الكبرى «التي تضفي المعنى على كل شيء».
وفي وصف هيدغر لنيتشه بأنه آخر العدميين في مسيرة الفلسفة اليونانية الغربية، دلالة حرص على «إعادة الاعتبار إلى الوجود وليس الموجود»، لأن الحياة بحسب هيدغر نفسه «تنصت إلى صوت الوجود وتستجيب لندائه».
بالنظر إلى رؤية الرجلين، وإن بدت على تقاطع نوعاً ما، إلا أنهما تلتقيان في بحثهما عن الحياة الإنسانية ومغزاها «وهي حياة تستند في كل أحوالها إلى الفعل الإنساني الواقعي».
صوت هيدغر ظل مرتفعاً بالتحذير من مستقبل الغرب «بما هو مستقبل العدمية الماحقة»، فيما لو استمر الاستلاب الحديث ماضياً إلى نهايته المتمثلة في التطور التقني. يتساءل بالفري: «هل وصل الإنسان المعاصر إلى هذا المستقبل؟ وهل صار هيدغر ومن قبله نيتشه، مجرد صوت من ماضٍ بعيد لا يسمعه أحد»؟
يرى بالفري أن انتشار شبكة الانترنت قدَّم للعالم صورة ليست هي التي كان عليها؛ إذ هو (العالم) قبل انتشارها شيء، وبعدها شيء آخر، وبالتالي مسَّ ذلك التغيُّر الثقافة نفسها، بظهور مصطلحات في مجال العلوم الإنسانية مثل: الثقافة الرقمية، والأدب الرقمي، والإعلام الإلكتروني، والتعليم الافتراضي. إلا أن أخطر ما ظهر من تلك المصطلحات نتاج تلك الثورة الرقمية هو ما أُطلق عليه الجيل الرقمي (Digital Natives)؛ بحسب ما أسماه مارك برينسكي، مؤلف كتاب «التعليم الرقمي المبنيُّ على اللعب»، والذي صدر في العام 2001، وأهم ما ورد فيه أن «هذا الجيل نشأ في عالم رقمي ونما وعيه بتأثير التكنولوجيا الرقمية، فتشكَّلت قيَمه وثقافته وسلوكياته تبْعاً لما يمارسه رقمياً في عالم تغلب عليه الافتراضية».
جيل غوغل... الكائنات الرقمية
ينوِّه بالفري إلى أن المكتبة البريطانية أجرت دراسة مع لجنة تقنية المعلومات المشتركة (JISC) (Joint Information Systems Committee)، بغرض تقييم تعامل جيل الشباب مع الإنترنت، «فحدَّدت الجيل الذي ولد بعد العام 1993، بأنه جيل غوغل (محرِّك البحث الشهير)» وقد تضمَّنت الدراسة إجراءات منهجية تهدف إلى التعرُّف على كيفية اعتمادها هذا الجيل وأشكال بحثه في الموارد الرقمية مستقبلاً.
في السياق نفسه، وعودة إلى جوناثان إيم، في مقاله «نحن كائنات رقمية» يرصد بعضاً من هذه القيم؛ إذ يرى أننا اعتدنا السخرية من الأشخاص المهووسين بالتواصل مع أصدقائهم عبْر شبكة الإنترنت، بدلاً من التواصل الحي المباشر. وأيضاً ممن يرون شبكة الإنترنت مصدرهم النهائي في كل شيء «ومع ذلك فمجتمعنا يتصالح الآن - وإنْ كان ببطء - مع حقيقة أن جيلاً بأكمله ينمو ولا يعرف سوى العصر الرقمي، فنحن ندعو أنفسنا جيل الكائنات الرقمية».
من بين القراءات التي تقترب من النبوءات - إذا شئتم - وهي ليست كذلك، لأنها تستند إلى منهجية إحصائية، وتتبُّع لكل المتغيِّرات التي تحدث من حولنا ضمن هذا الفضاء الافتراضي، والأدوات التي تسهم في اتساعه وامتداده، ومن ثم تثبيته وتجذّره في عالم اليوم، ما يراه جوناثان من أن المستقبل سيفرض الكثير من التحديات على المجتمع حتى يتماشى مع طرق تفكير الجيل الرقمي وأسلوب حياته؛ بل يتجاوز ذلك إلى المشاريع التجارية وما يرتبط بها، يقول إيم: «حتى في المشاريع التجارية الخاصة بنا، نتوصل أيضاً بشكل مستقل عن أي اعتبار بالمكان والزمان؛ إذ ننساق تلقائياً إلى توقع رد فعل سريع من شركائنا في العمل... فنحن الكائنات ذات الهوية الرقمية، نتوقع الحصول على المعلومات في مكان العمل بالسرعة التي يتيحها محرِّك البحث (غوغل) اليوم؛ سواء من العاملين معنا أو من أنظمة معلومات الشركات (...)».
الأزياء الافتراضية... الحياة الثانية
في الشواهد التي يمتلئ بها الكتاب، يستند هنا إلى ما ذكرته صحيفة «الواشنطن بوست»، من أن مصمِّمة الأزياء فيرونيكا براون - قبل سنوات من اليوم - استطاعت كسب آلاف الدولارات من تصميمها الأزياء الافتراضية التي يرتديها ساكنو هذا العالم الافتراضي، بل وقامت مجموعة من الشركات العالمية الكبرى بفتح فروع لها هنا، ومن أبرزها شركة آي بي إم وتويوتا وديل وصن ميكروسيستمز، مع أمر لافت تمثَّل في السويد بافتتاحها مقراً لسفارتها في الحياة الثانية (Second Life)، وقد قام بافتتاحه وزير خارجيتها.
في الكتاب وقوف على «الحياة الثانية» (الرقمية)، بالاختلاف الذي يميِّز أهدافها عن ألعاب الأون لاين. فالحياة الثانية ذات هدف مفتوح «مما يشعر ساكنيها بالحرية في تكوين البيئات التي تناسبهم، ومن اللافت للنظر أن بعض الباحثين الذين يسكنون هذه الحياة الافتراضية بأسمائهم الحقيقية، قاموا بالتجول في هذا العالم، وقدَّموا محاضرات، أو روَّجوا لمؤلفاتهم على نحو ما فعل لاري ليسيج، حيث اتفق مع ما يقرب من مئة شخصية افتراضية للتجمُّع في مكان افتراضي يسمَّى بولاي، فتحدَّث معهم عن كتابه الجديد «الثقافة الحرة» (Free Culture)، وقام بتوزيع نسخ إلكترونية منه والتوقيع عليها افتراضياً.
ماذا لو اختفى العالم الافتراضي؟
ربما تقود الأسئلة التي يكتنز بها الكتاب إلى نوع من استشراف الحلول والبدائل في المستقبل. الأسئلة بطبيعتها تعمل على تنشيط المخيلة، وتمنحها تلمُّس طرق ربما لم تقترب منها. ثم إن الأسئلة تلك تملك في كثير من محاولاتها قدرة على مواجهة المشكلات التي تعاني منها الوسائط والوسائل تلك مستقبلاً، علاوة على المشكلات التي يواجهها سكَّان العالم الافتراضي.
من بين الأسئلة تلك، ما الذي يمكن أن يخلقه مثل هذا العالم الافتراضي في وعي أبناء هذا الجيل الذي يمثل الشريحة الحياتية الغالبة والمؤثرة في العالم الآن؟ بصيغة أخرى معكوسة كما يحلو لمؤلفيْ الكتاب: ما الذي يمكن أن يواجهه أبناء الجيل الرقمي إذا اختفى عالمهم الافتراضي واصطدموا بالعالم الحقيقي؟ يعود المؤلفان إلى حكاية جوناثان التي بدأ بها هذا الاستعراض، كي يستخلصا منها تأملاً، بتعطُّل القطار «فلعلنا نفهم أنه لا بديل عن الحياة الرقمية لجيل لا يفكِّر أو لا يستمتع بالحياة إلا عبر الأجهزة الرقمية، ومن ثم يمكنك التنبؤ بحدوث شلل في حياة هذا الجيل حين يتوقف نبض العالم الرقمي».
عودة إلى المهتم بشئون التعليم في الولايات المتحدة الأميركية مارك برينسكي، الذي أدرك أنه إزاء هذا الواقع الرقمي الذي لا فكاك منه، هنالك ضرورة لخلق خطاب تعليمي يناسب العقلية الرقمية، داعياً إلى تطوير الأساليب والتقنيات بما يحقق الأغراض التعليمية، حاثَّاً المعلمين على الاجتهاد في تعلُّم أنماط الحياة الرقمية، وأن يكتسبوها من طلابهم، منبِّهاً إلى أن هذا الجيل يقدر على صناعة العلم والمعرفة بنفسه، دون حاجة إلى أستاذ يخاطبه بلغة تقادم عليها الزمن.
الأسئلة هي ما يخلص إليها المؤلفان سعياً وراء الوقوف على ما تحقق وأثَّر وأحدث انقلاباً في الحياة عموماً، وهو وقوف لا يكتفي بتلمُّس الظاهر والسطح من تلك المتغيرات، بقدر ما هو وقوف يستشرف المستقبل إلى أبعد بكثير مما تحقق، وتحمل تلك الأسئلة ما يرتبط بالإنسان نفسه... يرتبط بنهايته أو العكس «هل نشهد في هذا السياق المختلف والجديد تماماً نهايات الإنسان»؟
يحضر دريدا هذه المرة باعتباره أحد وجوه الفلسفة الغربية المعاصرة، وخصوصاً الفلسفة التفكيكية، التي بشرت فلسفياً بهذه النهاية «في مقاله (نهايات الإنسان)، يقوم دريدا بتفكيك خطابات النزعة الإنسانية، ويكشف عن أن دعوة نيتشه أو هيدغر، أو حتى ميشيل فوكو، دعوات إنسانية تم بناؤها في عالم الخطاب اللغوي على نحو استعاري (خيالي)، وما دام العالم الرقمي الافتراضي يحتوي العالم الحقيقي - بما فيه الخطاب اللغوي الذي يستخدمه الإنسان من أجل التواصل - فيشكِّل معالمه على هذا النحو، فهل أصبحنا مضطرين إلى حزم حقائبنا الافتراضية والاستعداد للهجرة إلى الحياة الثانية (Second Life)؟ ربما».