
مرَّت يوم الاثنين الماضي (21 مارس/ آذار 2016)، الذكرى الثالثة والتسعين لميلاد واحد من أهم شعراء الرومانسية، والهجاء - على رغم تحفُّظ عديدين على شعره السياسي - في العالم العربي: نزار قباني، من دون فعاليات مُلفتة - عربياً - بينما احتفل مُحرِّك البحث «غوغل» بالذكرى من خلال تصدُّر صورة الشاعر صفحته الرئيسة على الموقع.
مقال لقبَّاني نشره في مجلة «الدوحة»، وصدر ضمن عدد المجلة لشهر فبراير/ شباط 2016، احتوى مقالات من ذاكرة صفحاتها، قبل أكثر من 30 عاماً، وتحديداً في عدد يوليو/ تموز 1976م، حمل عنوان «نزار قبَّاني يتحدَّث»، قال في جانب منه، تناولاً للشعر ودوره وقضيته والتأثير الذي يُمكن أن يُحدِثه: «ليس مطلوباً من الشعر - بالطبع - أن يُحدث تأثيرات فورية. إن القصائد ليست فرقة مظلَّات تأتي إلى مدينة وتحتلُّها في خمس دقائق».
جزء كبير من المشروع الكتابي لقبَّاني، من دون الدخول في تصنيفه شعراً أو نثراً، ظل مُهيمناً في حضوره من خلال التصنيف الأول. لم يُقرأ نثر قبَّاني كما يجب، وهو المُوغل في شعريته حدَّ التماهي، وحد تحطيم الفوارق والاشتراطات التي تحكم كل واحد منهما، بتلك القدرة على اختزال المفاهيم، وأحياناً عدم الانشغال بها، خارجاً على الناس/ القرَّاء بمفاهيمه الخاصة التي كثيراً ما تتعارض مع كثير من الحقائق والواقع الذي يتناوله، بتلك التهويمات والحساسية الشعرية التي لا يُمكنها أن تحل محل مبضع التشريح أو التشخيص.
في الشأن السياسي الذي توغَّل فيه بعد نكسة حزيران العام 1967، تشكَّلت انعطافة أخرى في المشروع الشعري لقبَّاني. انعطافة أحدثت إرباكاً في مشروعه الشعري الرومانسي المُجدِّد والجريء، وأحياناً البذيء؛ كما يراه كثيرون، مروراً بمقتل زوجته بلقيس في انفجار بيروت في ثمانينات القرن الماضي، والذي استهدف السفارة العراقية؛ وصولاً إلى وفاة ابنه توفيق الذي رثاه في قصيدته «الأمير الخرافي توفيق قباني».
ذلك الانتقال لمَّح إليه في المقالة المذكورة، في تحوُّله من شاعر الحب والمرأة والياسمين والقمر، وكل ما يُغدق به علينا قاموس العربية في جانب رهافته، إلى شاعر السكِّين والجرح والجَلْد والتعرية أحياناً «الذين يقولون إن نزار قبَّاني استطاع أن ينتقل من شاعر الدانتيل المرفَّه، إلى شاعر السكِّين المرهف لا يدركون حركة التطوُّر التاريخية، وحركة تطوُّر الإنسان»؛ ولعل مقطعاً من أحد نصوصه يضعنا أمام واقع تلك الانتقالة: «يا وطني الحزين...
حوَّلتني من شاعر يكتب شعر الحب والحنينْ...
لشاعر يكتب بالسكِّين...».
هل هو ردُّ فعل على حدث انتاب الوجود الجمعي، أم رد فعل طال الذات؟!
ليست تلك وظيفة الشعر
في شعره، كما نثره، عملت رؤاه السياسية الحادَّة والصادمة على إرباك مشروعه الذي عُرِف به في العالم العربي منذ أربعينات القرن الماضي (1944)، وكان وقتها مازال طالباً في الجامعة حين أصدر ديوانه الأول «قالت لي السمراء».
مقال موضوع الاستعراض «نزار قبَّاني يتحدَّث»، كان إضاءات وشذرات حول رؤيته للشعر، لم تتخذ سمة منهجية بقدر ما كانت محكومة بفضاء مفتوح على اللغة، بتلاعبه بها. تبدو أفكاراً غير مرتَّبة، وغير منهجية، ولم تنفصل عن شعرية هي المرجع وهي الختام، لكنها في النهاية لا تقدِّم صيغة منهجية في تعريف أو دور أو تأثير الشعر في عالم يحتكم إلى القوة، ويحتكم إلى الاستحواذ.
عن نفسه يبدأ المقال «حين أتأمَّل قاعدتي الجماهيرية في العالم العربي، أشعر أني نجحت إلى حدٍّ ما في أن أُوصل صوت الحقيقة إلى الناس... كل الناس». من قال إن الشعر... من قال إن شاعراً في الدنيا ادَّعى إمكانية أن يقوم الشعر بذلك الدور: أن يقول الحقيقة كل الحقيقة للناس؟! ذلك جانب من الوديان التي يهيم فيها تحت عناوين مثل «التنظيرات» وهي ليست كذلك البتة.
لا مدى يمكن أن نحكم به الشعر، حتى في التعبير عن قضايا الإنسان، والوجود والحرية، لكن الإمعان في تلك الشعرية يُفرغ تلك القضايا من مضامينها، ويبتعد بها، من خلال أفق مُصطنع يبتغي منه حلولاً وشيئاً من المخارج، وتشخيصاً للأزمات. الشعر لا يملك، وليس ذلك دوره. الشعر لا يُشخِّص الأزمات. قد يُشير... يُومئ... يُنبِّه إليها، ولكن التشخيص ليس وظيفته، والأهم ليس من وظيفته الحلول أيضاً.
في تغيير الأشياء
حتى في مقاله المذكور الذي يشير فيه إلى أن «وظيفة الشاعر أن يُغيِّر نظام الأشياء من حوله»، فيه وحوله نظر. من وظيفة الشعر أن يُغيِّر النظر إلى الأشياء، وليست وظيفته تغييرها، ولم يفعل، أو ليس ذلك دوره أساساً؛ لذلك لا يبدو حالماً هنا فقط في كثير من مساحات المقال، بل يبدو مُتطرِّفاً وغير عقلاني، وغير منطقي في تناوله لتلك القضايا. نحن لا نتحدَّث عن نص شعري هنا. في النص الشعري يمكن لأي منا أن يجترح عوالمه ومناخاته ورؤاه، وحتى كوابيسه؛ لكن الأمر بالنسبة إلى النظر والتشخيص تُصبح للمسألة شروطها وأدواتها، وطرق نظرها. يكتب عن وظيفة الشعر نفسه «أن يكون قنبلة موقوتة توضع تحت سرير أهل الكهف، وتحت أسرَّة المُتخلِّفين والانكشارية».
وفي المساحة الذاتية نفسها التي لا يغادرها قبَّاني، وتوهُّمه حقيقتها، بقدرة الشعر، أو دور الشعر في أن يكون مُباشراً ومسئولاً ومُضطلعاً بالتغيير، وليس عاملاً وأداة ضمن مجموعة أدوات، وضمن بيئات وظروف في الوقت نفسه. في البيئات والظروف العربية لا يمكن لهيئات دبلوماسية وعسكرية وتعليمية كبرى أن تُحدث التغيير الفاصل الذي يذهب إليه قبَّاني، ومن باب أوْلى عجْز الشعر عن القيام بذلك الدور، وخصوصاً بالوقوف على مستوياته المترهِّلة والممعنة في مباشرتها حدَّ الضجر، واشتغاله على مساحات من الوهم، نسمِّيها أحلاماً، وتبنِّيه من جانب لحالات من التحريض المشروع، الذي تتراجع أمامه الجماهير في حضور القوَّة والقمع والعنف المنظَّم. ضمن المساحة الذاتية التي بدأت بها الفقرة يكتب قبَّاني في المقال نفسه «إنني أكتب الشعر منذ ثلاثين عاماً... وشعوري أنني استطعت أن أوجد تحوُّلات كثيرة في المنطقة العربية». وعلينا أن نبحث عن تلك التحوُّلات التي أحدثها بالميكروسكوب؛ إلا إذا كان يتحدَّث هنا عن التحوُّلات في تلقي الشعر واستقباله، والتفاعل معه والتأثر به، لكن لن يتجاوز تأثراً في حدود القاعة والمسرح، والإصدار، واتساع قاعدة تلك الجماهيرية.
وهو ما يُشير إليه في المقال نفسه، ففي حين يمنح الشعر تلك السلطة والقدرة على «تغيير الأشياء»، وهو منفصل عن حزمة من الظروف والمناخات، يعود ليتحدَّث عن حقيقة وواقع الشعر في تلك الظروف والمناخات والبيئات. يشير إلى «أن الوطن العربي على رغم كونه وطن الشعر، إلا أنه لا يتسامح مع الشعر»، ضمن تفاصيل حصرها بالحدود ومساحة من حلم «التنقل» عودة بنا إلى عصور ما قبل رسم الحدود!
بكل ما سبق لا يمكن القفز على القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي صنعها قبَّاني لنفسه على امتداد الوطن العربي، ونظر ذلك الجمهور إلى الشعر؛ وخصوصاً باللغة الوسطى التي تكاد لا تشبه أي لغة في تاريخ الشعر العربي، من حيث سلاستها وبساطتها، واكتنازها بالمعاني والقيم، وفي حدود عملت عملها في تخريب ذهاب ذلك الجمهور إلى لغة شعرية بعيدة عن مناخاته.
تظلُّ أهمية نزار قبَّاني في شعره الرومانسي، أكثر منه في شعره السياسي المليء بالسخط والتذمُّر واللعب على مشاعر الجماهير المنفجرة من ذلك السخط والتذمُّر الذي لم يتقدَّم بها خطوة إلى الأمام، لتغادر المسرح استعداداً للنوم على خيباتها وهزائمها وإرادتها المسلوبة، وواقعها الممعن في تردِّيه وتأخُّره. شعر مثل ذاك على رغم أهميته في حركة الشعر العربي الحديث، أثبت أنه غير قادر على تغيير نظام الأشياء، ضمن واقع يفتقد نظامية الحياة أساساً!
وبالعودة إلى «الشعرُ ليس فرقة مظلَّات تحتل مدينة في خمس دقائق»، تأكيد لنفي ذلك الدور الذي حاول قبَّاني أكثر من مرة أن يُثبِّته، ليعود إلى إزاحته!
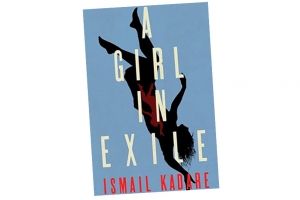



الله يرحمة
من أفضل شعراء العصر