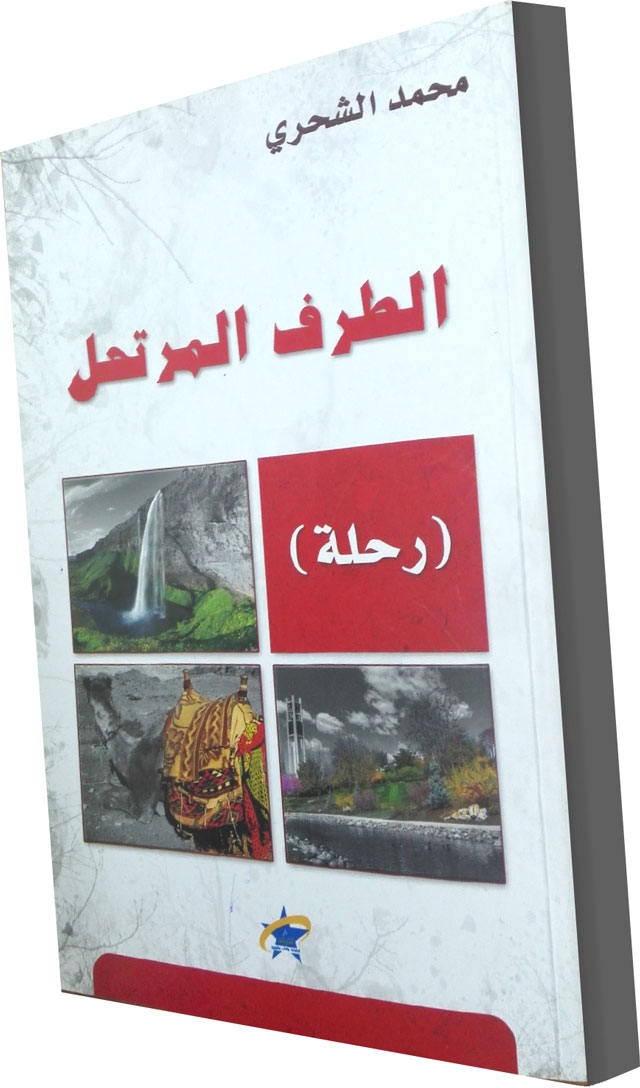تُحاول تجربة الكاتب والقاص العُماني محمد الشحري، في أدب الرحلات، أن تكون مُتاخمة لتجربته القصصية، بالقدرة على توظيف السرْد - يُلفت في مساحة، ويتورط في المباشرة في مساحة أخرى - هذه المرة ضمن المعاينة والحضور في الأمكنة التي لم تفتح شهيّته كي يلعب على وتر الاغتراب والهجرة، بقدر الكلام على/ عن السفر، باعتباره اكتشافاً للذات أولاً، دخولاً إلى اكتشاف الذوات الأخرى ثانياً، ومن خلال الأمكنة. أمكنة كثيرة هي واقعاً أوعية لاكتشاف الذوات. منها تصُيَّر، وبها يمكن الإمساك بجانب مهم من مرجعية تلك الذوات.
في المُقدِّمة التي تصدَّرت كتابه «الطرف المرتحل» الصادر عن دار الفرقد السورية في العام 2013، يكتب الشحري: «أنا هنا لا أروي هجرة أو اغتراباً، وإنما عن السفر سأحكي، عن تبدُّل الأمكنة والأجواء والجغرافيا والثقافة والحضارة سأتحدَّث، وسأنثر على بساط الحكايات مغامرتنا في الترحال بين مدن وجُزُر عبْر وسائط النقل الحديثة في الجو والبحر والبَر (...) إذن سأكتب عن تجربة خاصة عشْتها وعاشتها معي امرأة هي زوجتي رفيقة السفر والترحال، نودِّع أنفسنا، ونستقبل بعضنا بعضاً في مطارات ومرافئ ومحطات لا نعرف فيها أحداً ولا يعرفنا فيها أحد».
التجربة الخاصة التي أشار إليها الشحري في مُقدِّمة كتابه، لا يعنيها بحرفيتها. الكاتب بوعي - والشحري كذلك - لا يؤمن بالتجربة الخاصة في الكتابة بمعناها الضيِّق والاستملاكي، فمادامت إلى الناس كُتبت وتُكتب، وحين تكون في عهدتهم وفي متناولهم، لا تعود خاصة. إنها كتابة عن كل فرد منهم. عن كل مجموعة، في حضورها أو في السفر. إنها تقولهم في صورة أو أخرى.
التجربة الخاصة تقول العالم. مهما صغُر أو كبُر ذلك العالم. تقول المفارقات، وتلك التي تلتقي وتتشابه. في ذلك كله وقوف ونظر وتمحيص وتوظيف لتجارب كبرى تتمخَّض عن السفر والترحال. ليست رفاهية النفس وحدها هي الغالبة في كل ذلك. تتحدَّد الرفاهية أيضاً في المعرفة. أن تعرف، فذلك من نفائس الرفاهية وجوهرتها.
«عسَل الترْحال»
بدأ الشحري الرحلة من مسقط إلى مدريد ثم إلى جزر الكناري، والعودة مرة أخرى إلى مدريد ومنها إلى قرطبة وبعدها غرناطة ومنها إلى برشلونة، ومن هناك إلى باريس ثم البندقية (فينيسيا) وبعدها إلى جُزر باليرمو ومنها بحراً إلى تونس، ومن تونس إلى الجزائر، وبعدها الرجوع إلى مسقط. في رحلة عسل قضاها الزوجان بين أكثر من مدينة وعاصمة. بعض تلك الكتابات تعود إلى فترات سابقة توزَّعت بين الدراسة، كما هو الحال مع تونس التي قضى فيها الشحري 3 سنوات لدراسة الماجستير في الفترة ما بين العام 2005 و 2008. كتابات تحرَّت الأماكن... قرأتْها. وفي قراءتها قراءة للبشر الذين يُقيمون فيها. في محاولة الدنوّ منهم. الطريق إلى فهْم البشر كثيراً ما يتم من خلال الإقامة في المدن، لا العبور منها. العبور لا يتيح لك الإقامة في فهم البشر. عليك أن تُقيم وتُساكن وتُعاشر. بعض الأماكن أيضاً لن تتجلَّى لك أسرارها ما لم تقم علاقة مع المكشوف والمفضوح لدى البشر، وإذا استطعت الاقتراب من أسرارهم، ستتضح لك أماكنهم أكثر فأكثر.
يكتب الشحري معنى قريباً من ذلك. يسميه «المُتعة»، ولن تتأتَّى تلك المتعة إلا باستيعاب البشر وأماكنهم «لولا المتعة التي وجدتها في هذه الرحلة لما كتبت عنها شيئاً، ففي السفر ما يُمكن أن يُحكى وقصص يجب أن تُسرد. نكتب عن السفر ربما لكي نقول إنَّا كنَّا هنا في هذا المكان أو ذاك، على رصيف الشارع وداخل الغابة أو على شاطئ أو فوق قمة جبل، ومع مرور الأيام يصبح المكان الذي زرناه جزءاً من الذاكرة ومن الحنين».
ليس ذلك فحسب. لا تتموضع الزيارات تلك في الذاكرة، وفي مساحة الحنين. لها أثرها الذي ينهض، واستفزازها أحياناً، وقدرتها على استدراج المكان والإتيان به إلى حيث نحن، في ما يشبهه، وما يُذكِّر به.
يقظة تصنعها جماليات اللغة
بعض التفاصيل للدخول إلى المدن أو الإقامة فيها، والتجوال في أحيائها، وتمعُّن بشرها، ربما لا يعني القارئ شيئاً إذا تقمَّصت الكتابة دور الكاميرا. مثل تلك الكتابة لا تُشيع فنَّاً، ولا تُؤسِّس لكتابة الترحال كما يجب.
شيء من ذلك يتورَّط فيه «الطرَف المُرتحل» للشحري، وهو ما يُفقده القدرة على الرؤية من الداخل. أن يكون جزءاً من تلك التفاصيل. (صوت السارد) هو صوت الداخل إلى المكان، لا صوت الداخل فيه، والملتحم بتفاصيله وبشره. صوت الذي لا يذهب أبعد من أمكنة يتوزَّع فيها، ضمن تعامل ظاهر وفوقي.
كل لغة تأخذ دور الكاميرا في التعامل مع ظاهر وسطح الأمكنة لا يُعوَّل عليها. بمعنى أنها لم تقم باكتشاف المكان، ما بعد العين، وما بعد الحدقة.
في ثنايا ذلك النظر والتأمُّل ثمة يقظة تصنعها - واقعاً - جماليات اللغة واللعب بها. الخروج على النمط التسجيلي لما يتم رؤيته. يحدث ذلك في بعض أو مُفتتح رصْد وتسجيل ذلك الترحُّل، وسرعان ما يلوذ بالكلام المباشر، والنظر المباشر، والتأمل المباشر، الناتج بالضرورة عن لغة ممعنة في مباشرتها حد الضجر! هنا مساحة من التغلُّب على المباشرة تلك، بدرجة ما. ذلك التذبذب والانحسار في حضور تلك المساحة الشعرية، لا يتيح انشداداً لقراءة «الطرف المرتحل». فقط عندما تتجلَّى تلك المساحة.
«سأكون في السفر مسئولاً عن نفسي وعن شخص آخر معي هو زوجتي ورفيقتي في هذه الرحلة، وكنت هيَّأت نفسي لهذا السفر بكل حزم وحرْص العرب الجنوبيين ويقظة البدو الرحَّل الذين تحسبهم لا يبالون لشيء لكنهم يرصدون تحركات كل الأشياء المحيطة بهم ولا يفلتون الحذر والانتباه».
الغابات... موطئ البشرية الأول
في الفضاء نفسه نقرأ: «بعد فطور سريع في مطعم الفندق، خرجنا نسأل عن محطة المترو، كان الخريف قد ترك آثاره على الطرقات؛ حيث تعلو الأرصفة أوراق الشجر المتساقطة والمتناثرة هنا وهناك، وكأنَّ عمَّال البلدية يتعمَّدون ترك هذه الأوراق على الأرصفة كترحيب بالزائرين، الذين يستمتعون بوقْع أقدامهم على الورق الجاف، فيشعر المرْء كأنه يخطو في الغابات موطئ البشرية الأول».
تحضر فيروز، في السفر والحضر. كأنها بذلك رسولة الرفْقة الدائمة، وتعويذة الصوت الذي ينتخب كلامه من أكثر التجارب حدَّة وحساسية كي يكون لائقاً بفضاء ذلك الصوت!
«ورقو الأصفر شهر أيلول... تحت الشبابيك ذكرني ورقو دهب مشغول... ذكرني فيك رجع أيلول... وأنت بعيد بغيمي حزيني... قمرها وحيد بيصير...».
تظل سيرة السفر ملازمة لسيرة المكان الذي لن يظل عابراً بعد زمن، وإن كان الإنسان فيه عابراً. مثل تلك السيرة بحاجة إلى أدوات ذات حساسية عالية؛ ليست اللغة وحدها. هي بحاجة إلى أن تقدِّم نفسك إلى المكان. وعلينا أن نعرف أن بعض الأمكنة تجفل من البشر، والذين لم يجدوا يقبضون عليه جمالياً في أمكنة ما، قد يكونون هم السبب لا الأمكنة.
«يوجد في ساحة الأمبير ما يخطر على البال من فنون التسلية ومُتَع الفرْجة، منهم من يعزف على كؤوس الماء وكأنه يضرب بأنامله على لوحة مفاتيح البيانو، ومنهم من يحرِّك الدُمى ليجعل من المكان مسرحاً مفتوحاً، وهناك أيضاً من هو على هيئة السَحَرَة بلباس أسود وأنوف معقوفة ومكانس القشِّ، كل من لديه موهبة يستطيع أن يوظِّفها ويستثمرها في هذه الساحة، حتى الوجوه ولون البَشَرَة يمكن استثمارها، مثل الرجل الإفريقي المُنغمس في جبَّة خضراء ويطلق صيحات تشبه صيحات الرعاة في بلادي (...)».
باريس مدينة الهياكل الحديدية
في مفاصل كتابات الترحُّل، يصبح استدعاء التاريخ ضرورة أحياناً، على أن تكون عابرة. ألَّا يتحول درس الترحُّل إلى درس في التاريخ.
يستعيد الشحري أدواته وحساسيته في كثير من مفاصل الكتاب. تلك الاستعادة هي التي تقف عندها أمام ما استحوذ عليه وتمكّن من إدخاله في حالة خاصة تعنيه، وهي بالتالي تعني بطريقة أو أخرى مجموعاً بشرياً اقترب من تلك الكتابة أو كان بعيداً عنها. مكان يخشى على البكارة فيه والعفوي، دون تدخُّل من هندسة أو تخطيط تفرضه الحروب والصراعات وحتى ضرورات اختراع شهيات لدوران عجلة السياحة. أن تحتفظ مساحات المدن التي تشكِّل ذاكرة البشر وانشغالهم بالحاضر والمستقبل عَصب الالتفات، وقلب الوجل مما قد يطرأ عليها من خسْف جذبٍ لا يُراعي ضرورات، أو حملات إعلامية عينها على ارتفاع الأرصدة في المصارف؛ فيما هي تهوي بقيمتها والأثر والدور والتأثير والحضور المهيمن!
«أي وجه هذا الذي استقبلتني به باريس؟ هل كانت في حالة غضب أم أن طبيعتها هكذا مع الغرباء. هذه المدينة التي تمتصُّ الجمالَ ثم تلفظه خارجها هياكل عظمية وأحياناً معدنية كبرج إيفل».
تنفتح الشهيَّة لحظة الكتابة عن باريس؛ سواء كانت معها أو نيْلاً منها. نيْلاً من تقلُّبات الزمن الذي استحوذ على الشغف الذي يمكن رؤيته على بُعد حنين منها، وتوحُّد بها. رأى في جانب منها قدرتها على إعادة إنتاج القبح والبشاعة والحديد، على رغم نومها على الكنوز المعرفية للدنيا. وكذلك الكنوز التي استحوذت عليها حملات اجتياح المدن من أقصى الأرض إلى أقصاها، حيث تستقر هناك بقناعة أنها علامات لهيمنة فرنسا وامتداد اجتياحها بالنار، وكذلك اجتياحها بالمعرفة في أدق تفاصيلها، والفن في أروع شهوده وشواهده.
باريس تُقاوم الشيخوخة
«بدَتْ لي باريس حين زرتها كعجوز تُقاوم الشيخوخة بوضع المساحيق؛ أو كرجل يسوِّد بياض شَعره، فلم يعد هناك ما يُغري الفضوليين - ربما - سوى ذلك الهيكل الحديدي المنصوب وسط المدينة، كان المهندس رجلاً ذكياً، فعندما رأى أن المدينة لا تستحق الزيارة أو أنها ستُنسى وسيهجرها الناس إلى مدن أخرى على ضفاف البحر المتوسط أو الأطلسي، صمَّم هذا المبنى العملاق، وثبَّته في وسط المدينة حتى يجذب أفئدة الناس، وكان له ما أراد (...)».
في ملامسة للتغيُّرات التي تطرأ على المدن، يمرُّ الشحري، مُذكِّراً وليس متأمِّلاً هنا، لأنه وفي مساحات غالبة في الكتابة عن باريس سيدخل في السرد المباشر لتفاصيل يومية لا تعني القارئ في شيء وإن عنَت الكاتب.
من ضمن أجواء هذا الفصل، يتناول الشحري كاتدرائية روتردام بلغة شعرية لا تخطئها ذائقة؛ وخصوصاً مع المساحات التي أوغلت طويلاً في تفاصيل غاية في البساطة والعادية.
«كنت متشوِّقاً لدخول كاتدرائية روتردام، متشوِّقاً أكثر من مذنب يبحث عن الخلاص والتطهُّر من الآثام».
«كانت كاتدرائية روتردام ناعسة في مساء يخلع رداءه على عتبات الشتاء، واستقبلنا الدفء داخل القاعة المُخصَّصة للصلاة، والتي تتهيَّأ لاستقبال أعياد الميلاد». هنالك أيضاً «ودَّعْتُ باريس التي صدَّتْ في وجهي أبواب غوايتها، وحرمتني من لذَّاتها ومُتَعها، فلم أجدْها كما وصفها موديستو بلوتو، أحد أبطال رواية (دفاتر دون ريغوبيرتو) للكاتب البيروفي ماريو بارغاس يوسا».
في الإشارة إلى ما فات ولم تقبض عليه حساسية أدوات القاص والكاتب العُماني محمد الشحري، لا ينفي قبضه الخلَّاق وبامتياز على بعض تلك المفاصل من الترحُّل؛ غير أن التفاوت في التعاطي معها يمكن تفسيره بصدمة المكان الذي ترتبك فيه وأمامه لغة أيٍّ منا في التعامل معه وتقديمه والنظر إليه.
تحضر بعد باريس البندقية التي تنال قسطاً من السهر على اللغة في تناولها، ربما لأن المدينة نفسها... ربما المكان نفسه مشحون بالشعر، أو كله شعر، ولن يكون عصيِّاً القبض على جانب منه.
«البندقية ليست مدينة مُنفردة ولا العيش فيها خارق لنواميس التكيُّف؛ بل هي أبعد من ذلك، كما أنها ليست مدينة كأي مدينة أوجدتْها حاجة الإنسان للعيش والمأوى؛ بل أسمى من أن تكون مدينة من بيوت وأحجار وشوارع وأرصفة، هي أشبه بدار تعبُّد؛ كصومعة راهب أو دَيْر ناسك، أو حضرة صوفي، أو شيء من قبيل المتعة الروحية الممتزجة بالعشق الوجودي. في البندقية يتآخى الماء مع النار، والبشر مع الحَجَر».
إيطاليا تتبرَّأ من صقلية
عن تونس يكتب: «للسماء أبوابها الزرق، للهيام ألف باب مشرع أمام العابرين على أجنحة الحلم، نحو الجنان المنشودة في مكان ما من هذه البرِّيَّة المُثقلة بالهموم. أي بلد يعوِّض الخضراء؟ أي أناس يألفها الفؤاد غير هنا؟!».
ربما ستتغيَّر الرؤية الآن؛ بعد تحوُّلات وانعطافات عرفتْها تونس منذ العام 2011 حتى يومنا هذا؛ ليس حول المكان، بل حول البشر الذين يشكِّلون المدخل الأساس للمكان في كثير من الأحيان. لا كتابة فارقة في الجزء المخصص لتونس؛ إذ لم تبرح الكلام العادي في كثير من التقاطات الشحري.
يمهِّد للكلام عن باليرمو الإيطالية بالتاريخ، تلك التي أسماها «مقذوفة إيطاليا إلى البحر». كتب عنها ياقوت الحموي في «معجم البلدان» بقوله: «بَلَرْمْ: بفتح أوله وثانيه وسكون الراء وميم، معناه بكلام الروم المدينة»، وصولاً إلى قوله «وفيها هيكل عظيم، وسمعت بعض المنطقيين، يقول إن: إن أرسطو طاليس مُعلَّق في خشبة في هيكلها، وكانت النصارى تُعظِّم قبره، وتستشفي به لاعتقاد اليونان به فعلَّقوه توسُّلاً إلى الله به»، ويضيف «في بعض الشوارع من بَلَرْمْ على مقدار رمية سهم، عشرة مساجد بعضها تجاه بعض، وبينهما عرض الطريق فقط فسألت عن ذلك فقيل لي: إن القوم لشدَّة انتفاخ رؤوسهم وقلَّة عقولهم يحب كل واحد منهم أن يكون له مسجد على حِدَة لا يُصلِّي فيه غيره ومن يختص به، وربما كانا أخوين وداراهما متلاصقتان وقد عمل كل واحد منهما مسجداً لنفسه خاصاً به يتفرَّد به عن أخيه، والأب عن ابنه (...)».
يبدو التوظيف التاريخي ضمن هذا الفصل مُوفَّقاً من حيث الزاوية التي انتخبها الشحري. تلك الصورة التي تبدو متدافعة ولكنه يستخلص أبرز سماتها وما ظل راسخاً في الذاكرة. الصورة الأخرى/ المُضادَّة لما تتجنَّبه المدن عن صورتها، ولكنها لا تفلح فيه دائماً.
«من يتأمَّل باليرمو على الخارطة يرى وكأنها جزيرة قذفتْها إيطاليا التي تشبه خارطتها الحذاء إلى البحر المتوسط، وكأن إيطاليا تتبرَّأ من جزيرة صقلية إلى الأبد، وتعلنها منطقة منبوذة من أوروبا، وهي تستحق أن تكون كذلك، نظراً لاختلافها عن المناطق الإيطالية والأوروبية، ونظراً لحالتها العجيبة التي لا تشبه إلا مدن النصَّابين والمافيا والجريمة المُنظَّمة. لا أتحامل على باليرمو التي يُفترض بها أن تكون وريثة الروح الشرقية للثقافة العربية الإسلامية التي انتشرت في المدينة عدَّة عقود، لكن صقلية تجرَّدت من كل شيء سوى القذارة والانطباع السيئ للزائرين عنها (...)».
كان من الممكن لـ «طرف المرتحل»، أن يكون أكثر بهاء وقدرة على القبض على ما بعد الأمكنة في بلاد بعيدة أو قريبة. القبض عليها بالنأي عن الحال التسجيلية التي ظلت مهيمنة في مساحات كبيرة من الكتاب، لأنها انشغلت بظاهر التفاصيل، وبظاهر الرفاهية في مساحات أخرى، في كثير من الأحيان إذا حدث سوء في توظيفها، غياباً وتغييباً للقيم الجمالية الكبرى، وإفراغها من عمق ما يتم النظر إليه، ليس عن قصد ربما، ولكنها قدرة بعض الأمكنة على استدراج البشر العابرين إليها، من حيث النظر إليها وفق «برَّانية» لا تكشف الكثير من أسرارها، وذلك لا يعني أنها لا تريد كشف مثل تلك الأسرار، فليست تلك وظيفتها. إنها وظيفة العابرين الباحثين عن الجماليات المخبأة فيها، والقيم الساكنة خلف الجُدُر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بشرها.
ضوء
يُذكر أن محمّد مستهيل الشحري من مواليد العام 1979، في ظفار بسلطنة عُمان. من أبرز الأدباء العُمانيين الشباب. ساهم في العديد من المؤلفات المُشتركة مثل: «شهادات في زمن الحكيم»، الذي أعدَّته لمى حبش، وصدر عن دار الشروق في عمَّان العام 2009، و «ليلى العطاء الإنساني»، الذي يتحدَّث عن المناضلة البحرينية ليلى فخرو، وساهم بدراسة علمية عن العلامة الجزائري «محمد بن أبي شنب: المرجعية الثقافية والبعد الفكري»، في أعمال الملتقى الدولي بجامعة الجزائر 15-17 ديسمبر/ كانون الأول 2009، كما نشر دراسة علمية بعنوان «ظفار في تحفة النُظَّار» تتحدَّث عن زيارة ابن بطوطة إلى مدينة ظفار العُمانية، و «العرب بين البحر والصحراء»، «رحَّالة عرب ومسلمون» المجلد الأول، الصادر عن مركز ارتياد الآفاق 2010، كما أصدر كتيِّباً عن فن «البرْعة» أصدرته وزارة التراث والثقافة العُمانية في العام 2010، ونشر دراسة علمية عن المعالم الثقافية والسياحية لولاية مرباط في كتاب «مرباط عبر التاريخ»، الذي أصدره المنتدى الأدبي وزارة التراث والثقافة في العام 2012، كما ساهم أيضاً في كتاب «عبدالرحمن النعيمي في عيون محبِّيه»، الذي أعدَّته لجنة جمع تراث مؤسِّس جمعية العمل الوطني الديمقراطي البحرينية (وعد)، المناضل عبدالرحمن النعيمي، وقد نُشر الكتاب في العام 2012.
صدرت له مجموعة قصصيّة بعنوان «بذور البوار»، عن دار الفرقد السورية في العام 2010، و «الطرف المرتحل» (موضوع الاستعراض والمراجعة)، وأخيراً رواية بعنوان «موشكا»، عن دار سؤال اللبنانية.